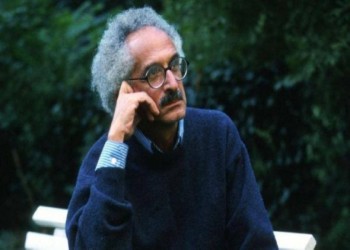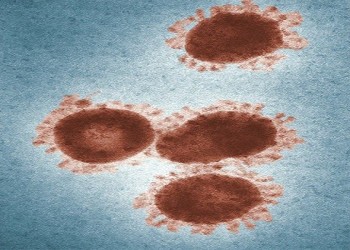ШӯШ§ШІЩ… ШөШ§ШәЩҠШ©
حين طُبّعت العلاقات بين دولتي الإمارات العربيّة والبحرين، و دولة إسرائيل، اتّجهت الأنظار فوراً إلى دمشق: كيف ستردّ قلعة الصمود والمقاومة؟ هل ترضى بالتطبيع، وفي الذاكرة كلّ ما قالته عن أنور السادات وياسر عرفات والملك حسين وأمين الجميّل؟
دمشق لم تردّ على الخطوة الخليجيّة - الإسرائيليّة. لقد رضيت بما حصل. حتّى العبارة الشهيرة التي تقال تعليقاً على الضربات العسكريّة الإسرائيليّة، من أنّ سوريّا تختار زمان الردّ ومكانه، لم تُسمع. رئاسة الجمهوريّة ووزارة الخارجيّة والتلفزيون والإذاعة كلّها صمتت. تُرك الأمر للموظّفين: بثينة شعبان، المستشارة الإعلاميّة والسياسيّة للرئاسة السوريّة، قالت لقناة «الميادين»: «لا أعلم ما هي مصلحة أبوظبي؟». لقد حلّت اللاأدريّة فجأة محلّ اليقين. «حزب البعث العربي الاشتراكيّ» تولّى الردّ: لقد ندّد، في بيانين حادّي اللهجة، بـ«العدوان السافر على القضيّة الفلسطينيّة وحقوق الشعب الفلسطينيّ». لكنّ كلام البعث كلام بعثي لا يُحمل على محمل الجدّ.كتّاب ومعلّقون ذهبوا، في قراءتهم هذا الصمت المصحوب بظروف سوريّة أخرى، أبعد من ذلك. تساءلوا: متى يذهب بشّار الأسد إلى تلّ أبيب؟ متى يبدأ التفاوض السوري - الإسرائيلي برعاية أميركيّة؟
هذا لم يحصل حتّى الآن. لكنّ شيئاً منه حصل في البلد المجاور الذي لا يقلّ ممانعة عن الجار الأكبر: لبنان. رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي أعلن عن التوصّل إلى «اتّفاق إطار» لبدء محادثات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل. أمّا أن يأتي الإعلان من برّي، حليف «حزب الله»، لا من رئيس الجمهوريّة ميشال عون، فيوحي أنّ الدولة الموازية، لا الدولة الأصليّة، هي التي تبادر وتشارك في تحمّل المسؤوليّة.
يزيد في فداحة ما حصل أنّ الأمم المتّحدة سترعى العمليّة وتشرف عليها. لكنّ الفداحة تبلغ ذروتها حين تلعب الولايات المتّحدة، أي «الشيطان الأكبر»، دور الوسيط والمسهّل لهذه العمليّة.
الحدث الخطير ترافق مع لغة جديدة تتحدّث عن «المصالح المشتركة» و«تنمية الموارد» و«شعوب المنطقة». إنّ في الأمر رائحة تطبيع ما مع «كيان صهيونيّ» نشكّك بوجوده!
تصاحب ذلك مع شيء آخر غير مألوف: انتشار قوّة عسكريّة من قوّات الطوارئ الدوليّة (يونيفيل) في بيروت ومنطقة المرفأ. جريدة «النهار» ذكرت أنّ الانتشار تمهيد لتمدّد قوّات الطوارئ نحو الحدودين الشرقيّة والبحريّة «وإيكالها مهمّات مراقبة جديدة لمنع عمليّات التهريب، تحقيقاً للرغبة الأميركيّة التي أعربت عنها واشنطن إبّان مناقشة مجلس الأمن قرار التجديد لهذه القوّات في أغسطس/ آب) الماضي وعدم استمرارها مقيّدة». للتذكير فقط: «حزب الله» لم يكتم عداءه الشديد لتوسيع عمل قوّات الطوارئ التي لم يتوقّف عن اتّهامها بالسهر على خدمة إسرائيل، كما دفع «الأهالي» (؟!) غير مرّة للاصطدام بها.
إذن، بعيداً من الخطابة الرنّانة حول إسرائيل وفلسطين، ومن الكذب المتمادي على الفلسطينيّين، ثمّة شيء آخر يجري في المنطقة:
في 7 مايو (أيار) الماضي، يوم كُلّف مصطفى الكاظمي بتشكيل حكومة عراقيّة جديدة، لاح كأنّ صفحة بدأت تُطوى: الإيرانيّون وميليشياتهم في العراق يوافقون على ترئيس رجل كانوا يشتمونه ويخوّنونه قبل أيّام. أحد فصائلهم (كتائب حزب الله) لم يتردّد في اتّهامه بالتواطؤ في مقتل قاسم سليماني.
هنا بدأ الشكّ الإيراني بحظوظ المشروع الخميني في منطقة المشرق. استعادة حركة «حماس» إلى الصفّ الممانع قليلة جدّاً ومتأخّرة جدّاً: طهران مستنزَفة اقتصاديّاً ومعزولة إقليميّاً ودوليّاً. حليفها الأسد يملك ولا يحكم، فيما الصوت الأقوى في سوريّا هو الصوت الروسيّ. نظام إيران سيّد العارفين بهذه الحقيقة. «حزب الله» والميليشيات الشيعيّة العراقيّة ليست في وضع شعبي تُحسد عليه في بلديها. هذا ما كشفته ثورتا البلدين، ثمّ فاقمه، في لبنان، انفجار المرفأ.
هذا لا يعني أنّ «محور الممانعة» استسلم، أو أنّه يستسلم. إنّه، على الأرجح، يخوض قتالاً تراجعيّاً يملأ به الوقت الضائع في انتظار الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة. والقتال التراجعي هذا من شقّين: تقديم التنازلات من جهة، وممارسة الشغب من جهة أخرى. في خانة التنازلات يمكن أن نضع الانحناء أمام التطوّرات التي سبقت الإشارة إليها، أمّا في خانة الشغب فيندرج إفشال المبادرة الفرنسيّة في لبنان، وإطلاق الصواريخ «الغامضة» في العراق.وهي، على قصرها، قد تكون مرحلة مقلقة وحرجة يقدّم فيها الممانعون التنازلات لأميركا وإسرائيل، فيما يمارسون الضغط على من يعتبرونهم حلفاء محليّين لأميركا وإسرائيل. هذا سلوك ينتمي إلى مدرسة عريقة عندنا، مدرسة كان حافظ الأسد أستاذها الأبرز.