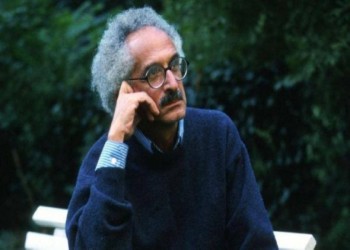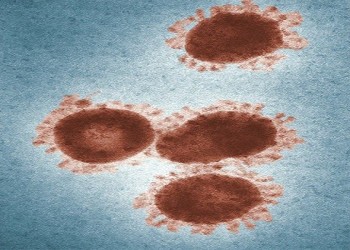الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
لا اقتصاد من دون الفصحى

سوسن الأبطح
سوسن الأبطح
الاحتفاليات باليوم العالمي للغة العربية في وادٍ، والواقع في وادٍ آخر. الدساتير العربية تشدد على الهوية، والحياة العامة، تتفرنج كل يوم أكثر. وقبل أن يصبح الحرف العربي فرحة مصممي الموضة، وبهجة الفساتين، ولفحات الرقبة، وأقمشة الكنبات، كان تلامذتنا يتعلمون الكتابة بخطوط مقروءة وواضحة، وصارت كتاباتهم كخرابيش الدجاج.
قد لا تكون ثمة علاقة بين تنامي الاحتفاليات والتعبير عن الحب للغة، والانحدار الكبير في مستوى الخريجين. لكن الملاحظة نفسها تبعث على الأسى. الشكوى لا تقتصر على بلد واحد. ففي جامعة الكويت يعاني الأساتذة من تدني مستوى طلابهم الآتين من الثانويات، في الإملاء والتعبير اللغوي، وبعضهم لا يجيدون كتابة أسمائهم. وأضيف من تجربتي اللبنانية، أن كل فوج طلابي يصل بمستوى أدنى من الذي سبقه. وبما أن الجامعة ليست مكاناً، لتعليم الإنشاء والخط، وإنما البحث والتفكير والتحليل، فإن الخروج من النفق يصبح عسيراً. إحدى طالباتي في قسم اللغة العربية، سالت عن جدوى تدريس مواد الحضارات والآداب، ولماذا لا تُستبدل بها دروس التعبير والإملاء، ما دامت الحاجة فعليّة وماسّة؟ وهذا واقع سوريالي، من غير الممكن تخيله. في المسابقات تقرأ جملاً من نوع: «أعلن الإسلام بهدم الفوارق العصبية بين الأمة الإسلامية ليعمّ الأمان» أو «كانوا العباسيين» أو «المعتزلة هي مجموعة من العلوم والروابط التي تعمّ معظم الدول العباسية ومنهم الدول شمال العراق». وفي تعريف الفكر الانتقادي، يأتي جواب كالتالي: «إنه ترجمة حرفية لمصطلح غربي، ستترجمه انتصارات مبهرة، وإخفاقات خطرة، بموازات الملابسة التاريخية التي آثارها الزعيم، وترددت أصدائها في العالم العربي». وكما ترى فإن الكارثة، لغوية، وفكرية، وفي ضعف الخلفية، وركاكة التعبير، لا بل العجز الكامل.
الأخطاء تحدث، لكن ما عرضته عليك من الشيوع، في جامعات عربية كثيرة، بحيث تسأل نفسك إن كان بمقدورك أن تفعل شيئاً مفيداً، لإصلاح ما أفسده الدهر.
المشكلة مركّبة، نفسية أولاً، تبدأ من الإحساس الجماعي، من دونية العربية وعدم جدواها (وهذا هو الأخطر الأكبر)، ولا تنتهي بغياب الخطط الوطنية، والاستراتيجيات العربية المشتركة، ولا يتبقى، والحال هذه، غير الجهود الفردية المتواضعة، وكلٌّ يسعى بما أوتي من قوة، مع أن هذا وحده لن يُطعم خبزاً.
النظر إلى اللغة على أنها مجرد حاجة عاطفية ينطوي على قصر نظر. الدراسة الممتازة التي أصدرتها «مؤسسة الفكر العربي» مؤخراً، تحت عنوان «العرب وتحديات التحول نحو المعرفة والابتكار»، تقطع بصعوبة النهوض العربي الاقتصادي، إن لم يكن استحالته، قبل «أقلمة اللغة العربية مع الثورة الصناعية الرابعة، واستخدامها في مجالات هذه الثورة، مثل إنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والبيانات الضخمة، والذكاء الصناعي والحوسبة السحابية، وواجهات التفاعل بين الإنسان والآلة، والمدن الذكية». وهناك مَن يسأل عن السبب الوجيه الذي يمنع وجود محركات بحث عربية لأمة الـ400 مليون أو متصفحات، أو حتى وسيلة تواصل ناجحة وفعّالة تجمعهم.
وبدل أن نُلقي باللوم على وسائل التواصل الأميركية التي أصابت اللغة في مقتل، يجدر أن نستغل الأدوات الجديدة، ونمنحها هويتنا، ونجعل منها نافذة لنا، في خدمة حاجاتنا وأحلامنا. فهل يُعقل أن تدفع في بعض الكتب الإلكترونية العربية، لتحصل على نسخ، تصعب قراءتها أو التعامل معها، أو أن طبيباً لا يستطيع أن يشرح لمريضه حالته، لأنه درس كل المصطلحات بلغة أخرى، أو أن أطفالنا يتربون على ألعاب تتحدث كل اللغات إلا لعتهم. فإذا كان تدريس العلوم بالإنجليزية يجلب المنفعة الشخصية للطالب لأنه يسهّل حصوله على عمل بسبب التفرنج الحاصل، فإن الخسارة الجماعية هائلة.؛ فالعلم صار محصوراً بنخب منغلقة على ذاتها لا تستطيع أن توصل معارفها لبقية المجتمع، بينما النمو المجتمعي مُحال، ما لم تكن عدالة المعرفة وبلوغ المعلومة متاحين لكل الطبقات، وبالقدر نفسه.
التكنولوجيا أصبحت جزءاً من المشهد المعرفي العربي، وهذا جيد، لكن المحزن أننا أصبحنا «كتجمعات بشرية هجينة، ملحقة بمصادر المعرفة خارج حدود بلادها». ولا يبدو أن ثمة محاولات سريعة، لتغيير الصورة، مع أن كل ما تنتجه بغير لغتك، مهما بلغت أهميته، ليس ملكاً لك بل للأمة التي ينطق نتاجك بلغتها. فالمحتوى الرقمي يقاس فقط، باللغات التي يستخدمها، لا بالجنسيات ولا الأعراق.
ولولا بعض الصحافة التي لا تزال تؤمن بالفصحى، فيما نَحَت التلفزيونات صوب العامية، لكان الاستخدام اليومي للعربية اقتصر على المحكيات، ولما رأينا أي توليد أو تجدد في المفردات. وبسبب هذا القصور، فإننا غالباً ما نبحث عن مرادف لكلمة أجنبية فلا نجده، أو موازياً لمصطلح علمي يتبين أنه غير موجود، مع أن العربية بمرونة التصريف والتراكيب من الديناميكية بحيث يمكنها، لو أراد أبناؤها، أن تجاري كل ابتكار.دول مثل ماليزيا والبرازيل والصين استطاعت أن تحقق نمواً سريعاً باعتماد لغتها الوطنية في التدريس من دون أن تهمل، في الوقت نفسه، اللغات الأجنبية، مما أتاح لنخبها أن يشاركوا مواطنيهم أفكارهم ومعلوماتهم. أما المثقف أو العالم في ديارنا، فإذا ما طُرح عليه سؤال تجده يُتأتئ ويتلعثم ويخلط اللغات بعضها ببعض، فلا يبدو هو مقتنعاً بما يقول، أو ممتلكاً وضوح الرؤية، لإقناع الآخرين. وتلك كارثة، أن يظن الإنسان العربي أن العلم هو صنو الإنجليزية، وأن العربية خُلقت للمجالس العائلية والمقاهي وتبادل النكات.
GMT 09:12 2022 الأحد ,07 آب / أغسطس
الخضرة والماء والوجه الحسنGMT 09:08 2022 الأحد ,07 آب / أغسطس
اللبنانيّون وقد طُردوا إلى... الطبيعة!GMT 09:04 2022 الأحد ,07 آب / أغسطس
الضوء الأخضر للإرهابGMT 08:57 2022 الأحد ,07 آب / أغسطس
تايوان... «أوكرانيا الصين»!GMT 08:52 2022 الأحد ,07 آب / أغسطس
أصوات العرب: جوّال الأرضتوقيع اتفاقيتين لتسهيل مرور أنبوب الغاز "المغربي-النيجيري"
الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط توقيع مذكرات تفاهم بين شركة النفط الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن المغربي وشركة النفط السينغالية وشركة محروقات الموريتانية حول مشروع غاز نيجيريا-الم�...المزيدتامر حسني يؤكد إستمرار علاقته الفنية مع بسمة بوسيل ويكشف دعم محمد منير له منذ بداياته
القاهرة - الدار البيضاء اليوم
أحيا الفنان تامر حسني واحدة من أضخم حفلات صيف 2025 برأس الحكمة بالساحل الشمالي بحضور الآلاف من جمهوره من مختلف الجنسيات العربية . بدأ الحفل بصعود تامر حسني على خشبة المسرح مرددًا "ميدلي" استعراضي يضم عددًا من أغ�...المزيدانتقادات واسعة لـ"خرائط انستجرام" بسبب مخاوف الخصوصية وخطوات تعطيل الميزة
سان فرانسيسكو - الدار البيضاء اليوم
أثارت ميزة "خرائط انستجرام" الجديدة موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي بعد أيام قليلة من إطلاقها، حيث عبر عدد من المستخدمين عن استيائهم وقلقهم من تداعيات الميزة على الخصوصية الشخصية. واتهم البعض ا...المزيدرحيل صوت الحرية في الأدب العربي المصري صنع الله إبراهيم عن عمر 88 عامًا المتمرّد الذي ظلّ وفيًا للكتابة
القاهرة - الدار البيضاء اليوم
توفي اليوم الكاتب والروائي المصري صنع الله إبراهيم عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد معاناة صحية بدأت منتصف عام 2025 عقب إصابته بنزيف داخلي وكسور في الحوض، قبل أن تتدهور حالته مؤخرًا بسبب التهاب رئوي حاد. وقد شكّل خبر وفاته لح�...المزيدجورجينا تثير اهتمام الجمهور بعد موافقتها على الزواج وتخطف الأنظار بأجمل إطلالاتها
الرياض - الدار البيضاء اليوم
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©