الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
الروائي السوري فوّاز حدّاد لـ"المغرب اليوم"
اليساريون نادوا بالثورات قبل عقود ثم تنكروا لها

دمشق - جورج الشامي
أكّد الروائي السوري المعروف، فوّاز حدّاد لـ "المغرب اليوم" أن "رصد وقائع الثورة مهمة معقدة، وتشكل عملاً شاقاً بالمقارنة مع ما فعله الأميركي جون ريد في «عشرة أيام هزت العالم»، واعتبر "حداد الذي اهتم في معظم رواياته الإحدى عشر بتاريخ سورية المعاصر، وصارت مرجعاً للكثيرين لهذه الحقبة أو تلك" أغلب من انتقدوها الثورة وغسلوا أيديهم منها، كانت مواقفهم انسجاماً مع أدبياتهم اليسارية، فهم لا يستطيعون إلا أن يكونوا ماركسيين، حفاظاً على تاريخهم اليساري، فجهروا بمواقف مراوغة، تحت الشعارات اليسارية نفسها.
مع أنهم نادوا بالثورات قبل عقود، وبشروا بها خلاصاً من الدكتاتوريات، ثم تنكروا لها"، وقال "عندما نؤمن أن هذا البلد هو بيتنا، ولا مأوى لنا غيره، فلن نقصفه بالمدافع، وإذا كان هناك من يعتقد أن هذا البلد له وحده، فهذا هو الشر الخالص". وعن وجود خشية على الإبداع الجديد من «أيديولوجيا» الثورات المعاصرة يقول صاحب رواية "خطوط النار" إن "الخطر يأتي من الأيديولوجيات المغلقة الساعية إلى تجيير الأدب لتسويق مقولاتها النهائية، وعدم الاعتراف به إلا على أنه خادم لسياسة الرأي الواحد. ولذلك يخشى من ابتداع أيديولوجيا تحنط حق التغيير وأهدافه ووسائله إلى برامج تحفل بالممنوعات وتحدد المسموحات".
وبشأن أن غالبية الأدباء تسارعوا نحو الاصطفاف وراء الثورات العربية، وهل ينطبق هذا القول على الثورة السورية، قال حدّاد إن "ما يسري على الثورات العربية، لا يسري على الثورة السورية، لكل واحدة ظروفها الخاصة، فالسورية بسبب طول أمد حراكها، وضعت المثقفين على المحك، ما أسهم بإبراز خلافاتهم حولها، فخسرت قدراً لا بأس به من التضامن والتأييد، بعدما جرى التسارع إلى الاصطفاف وراءها. بعض المثقفين وقفوا منذ البداية موقفاً رافضاً لها، أو مشككاً فيها، متنبئين لها بأنها ستذهب غنيمة إلى الإسلاميين الأصوليين، ما أعفاهم من الوقوف في صفها".
وأوضح أن "البعض الآخر، سجل مواقف إيجابية نحوها، ثم ترددوا إزاءها، لتبدأ بعدها سلسلة من التراجعات المحسوبة تحت غطاء اتخاذ مواقف نقدية، منها مبطنة بنغمة محايدة، انتقدوا من خلالها النظام وأدانوا سياسته الأمنية في معالجتها. ثم ركزوا على انحراف الثورة عن أهدافها وسلميتها، وعبروا عن مخاوفهم من نتائجها الكارثية على البلد. فهم لا يؤيدون إلا على المضمون".
وقال إن غالبية من التحقوا بداية بالثورة، أو انتقدوها وغسلوا أيديهم منها، كانت مواقفهم انسجاماً مع أدبياتهم اليسارية، فهم لا يستطيعون إلا أن يكونوا ماركسيين، حفاظاً على تاريخهم اليساري، فجهروا بمواقف مراوغة، تحت الشعارات اليسارية نفسها. مع أنهم نادوا بالثورات قبل عقود، وبشروا بها خلاصاً من الدكتاتوريات، ثم تنكروا لها، واشترطوا اشتراطات تعجيزية، مع أن الذين تظاهروا في المدن والبلدات والقرى كانوا من الناس العاديين البسطاء والفقراء، رداً على الظلم الذي أصابهم، واعترفت به الدولة، ولم تنصفهم. وكانوا حالة مثالية لكي يساندها المثقفون الذين دأبوا على الترويج لها، لكنهم حسموا أمرهم معها، وعزوها إلى مؤامرة مدبرة في الخارج".
وأضاف "كان المعول على اتحاد الكتاب، والذي كنا نسمع عن مطالبات أعضائه بالمزيد من الحرية في اجتماعات الهيئة العامة، وبانتقاداتهم الجريئة في مناسبات شتى للإجراءات غير الديمقراطية المتخذة في داخله. المستغرب أن هذا الحدث المصيري الذي شمل سورية منذ أكثر من العام، الآخذ بالتفاعل يومياً، والمهدد بتمزيق الوطن، والذي كلف الشعب آلاف الضحايا من المدنيين والعسكريين!! لم يستلزم منهم اجتماعاً ولا حراكاً تتطلبه الظروف التي يمر بها البلد، واقتصر على إبداء الرأي في المكتب التنفيذي، الذي شهد صراعات في داخله لم تخرج إلى العلن. اكتفي فيها ببيانات ألحت فيه على «تحريم القتل من الأطراف كافة».
وقال حدّاد "لا بد من الاعتراف، بأن موقف الأدباء في اتحاد الكتاب، شكل خيبة كبيرة، كان من المتوقع أن نشهد مناقشات مؤثرة، تشكل ضغطاً على النظام بانتقاد تصرفاته التي لا تخفى على أحد، وكيف تهدر حقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم بالتظاهر السلمي، وإدانة الأجهزة الأمنية لاستعمالها القوة المفرطة، واعتقال الآلاف من أفراد الشعب، والعمل على تفتيت اللحمة الوطنية".
وقال حدّاد "للأمانة، هناك عدد من مثقفي الاتحاد وهم ليسوا قلة، أعلنوا مواقفهم المؤيدة للثورة بكل جرأة، غير آبهين لتعرضهم للاعتقال والفصل من الاتحاد وفقدان حقوقهم النقابية".
وقال "في المقابل وقعت حمولة الثورة الفكرية على المثقفين من الناشطين السياسيين، مثل ياسين الحاج صالح، ميشيل كيلو، سلامة كيلة، رضوان زيادة، علي العبد الله... وغيرهم كثير، داخل سورية وخارجها، على الرغم من خلافاتهم السياسية، وهي خلافات ضرورية وصحية. ما شكل من مقالاتهم رصيداً معتبراً للفكر السياسي السوري متقدماً على غيره، بالتصدي لتعقيدات المسألة السورية، التي أعادت من خلال إسهاماتهم تعريف الكثير من القضايا الجوهرية السياسية السورية، على الرغم من اشتباك الأوضاع الداخلية بالإقليمية والدولية".
وبشأن انعكاساتْ الثورة السورية أدباً وإبداعاً عند المبدعين السوريين، يقول صاحب رواية "جنود الله" يستحسن عدم التطرق إلى الأدب والإبداع والمبدعين السوريين، حالياً الساحة مفتوحة للكتابات السياسية. أما الكتابة الإبداعية فمقيدة اليدين، والأدباء ليسوا أكثر من مراقبين ومتفرجين، كما أن الحالة نفسها لا تساعد على الكتابة. نعم، الحدث متبلور، لكنه لم يأخذ أبعاده في ذهن الكاتب، الأدب يلهث وراءه، مازال في مرحلة اكتشافه من الداخل. لسنا طبعاً بانتظار النهاية السعيدة، وإنما في اكتمال شيء كي نتمكن من ضبطه داخل إطار ما.
وأوضح حدّاد "مهما حاول الكاتب، فهو متأخر عن اللحاق بركب الثورة، عموماً الكتابة الأدبية لا تسبق الثورة، بل تتأخر عنها. هذا بالنظر أيضاً إلى كتابات المثقفين في العالم، ففي قضية درايفوس، التي استهلها اميل زولا ببيانه «إني اتهم» معلناً كمثقف سياسي اتهامه للعنصرية والتمييز. لم تظهر في الأدب إلا بعد مضي زمن في رواية «البحث عن الزمن الضائع» لمارسيل بروست و«السيد برجيريه في باريس» لأناتول فرانس. كذلك حدث للثورة المصرية العام 1952، برز بعد سنوات في روايات نجيب محفوظ، وتأثيراتها في عشرات المسرحيات لأكثر من جيل كتب للمسرح مثل، يوسف إدريس والفريد فرج ونعمان عاشور ومحمود دياب ولطفي الخولي... ولنتذكر أن الثورة السورية ضد الفرنسيين حظيت بروايات معروفة مثل «لن تسقط المدينة» و«حسن جبل». للكاتب فارس زرزور. وما زالت تتردد أصداؤها في كتابات كثير من الروائيين السوريين حتى الآن".
وعن وجود خشية على الإبداع الجديد من «أيديولوجيا» الثورات المعاصرة، أكد صاحب رواية "خطوط النار" أن "الخطر يأتي من الأيديولوجيات المغلقة الساعية إلى تجيير الأدب لتسويق مقولاتها النهائية، وعدم الاعتراف به إلا على أنه خادم لسياسة الرأي الواحد. ولذلك يخشى من ابتداع أيديولوجيا تحنط حق التغيير وأهدافه ووسائله إلى برامج تحفل بالممنوعات وتحدد المسموحات".
وقال "أكثر ما تظهر الأيديولوجيات المتحجرة في أزمنة الصراع والحروب، وأيضاً الانتصارات، وتنحو إلى إلغاء الآخر، لاسيما وأن الثورات تُختطف، وبالتالي قد يُستخدم الأدب في الأوقات المضطربة ليعبر عن وجهات نظر صارمة، تدعو للقتل والكراهية والاستئصال، والتحريض على العنف، وهو ما يخشى منه، لاسيما وأن الأدب يصلح تحت مظهره البريء لتسريب فكر يزعم امتلاك الحقيقة المطلقة بتسويق ذرائع تدحض أي اختلاف، وتصفية كل معارضة. غير أن تجليات الأدب العظيم أكثر التصاقاً بالحياة منها بالموت".
وأضاف حدّاد "يتطلب تصفح تداعيات فصول الثورة السورية من الروائي فهم ما يحدث ليس في سوريا فقط، بل وما له شبيه دموي في العراق أيضاً، وفي لبنان، وما حدث قبل أشهر قليلة في النرويج البلد السعيد؛ القتل بدم بارد، وكأنه فعل إيمان مطلق بقضية لا يأتيها الباطل، على أنه تصحيح لمسيرة العالم، وردها إلى الصواب من خلال قتل البشر بالجملة".
ألا ينبغي فهم هذا التطرف المميت؟ لماذا يتكرر من حين لآخر بهذه الوحشية؟ مع أن من يقوم به صحيح البنية، ويبدو سليم المنطق؟ أليس هذا من انحرافات العقل والأديان معاً المستشرية في العالمين الغربي والشرقي، وكل حسب دعواه القويمة؟ ألا يحرضنا انحطاط النظر هذا على أن نكتب شيئاً لا يمسنا وحدنا أو يمس بلادنا فقط، بل يمس العالم أجمع وفي الصميم. هذا ما يحض الرواية على مقاربة الواقع، لا الخيال، لماذا الخيال في حين الواقع يقتلني ويدمر حياتي؟ إذا كان الخيال بديلاً عن الواقع، فهو تصنع واصطناع.
تنحو الكتابة ليس أن تكون الشاهد فقط، بل في كشف الحقيقة سافرة: الرعب والتعذيب والعمى الأخلاقي وهدر الكرامة البشرية في اشد صورها قسوة. هناك الكثير مما يجب أن نفهمه ونتعلمه ونجتنبه ونزدريه، ونشعر بالخجل والهوان من جرائه، لذلك ليس من العجب أن ندير وجهنا عن عالم لا يستحق العيش، وهذا ليس من الإنسانية، الواجب التصدي له. هذا الوطن سنعيش فيه جميعاً على قدم المساواة، لكن يجب أن يقتنع الآخرون أنه لا شيء يميزهم عنا، ويمنحهم الأفضلية بأن يحكموا ويتحكموا ويتسامحوا ويغفروا، أو يقتلوا.
وقال حدّاد "عندما نؤمن أن هذا البلد هو بيتنا، ولا مأوى لنا غيره، فلن نقصفه بالمدافع، وإذا كان هناك من يعتقد أن هذا البلد له وحده، فهذا هو الشر الخالص.
وعن أي مصادر يتابع يوميات الثورة؟ عبر الصحافة؟ التلفزيون؟ الفايسبوك؟ أم عبر مشاهداتك اليومية؟ هل شاهدت هذه المظاهرات عن قرب؟ ما الذي رأيته؟ كيف أثرت بك؟ وأي صور علقت لديك؟.
يقول حدّاد "سمحت لي وسائل الاتصال المتعددة بمتابعة يوميات الثورة عبرها مجتمعة: الصحافة، التلفزيون، المواقع الالكترونية، الفايسبوك، وأيضاً عبر مشاهداتي الشخصية المحدودة جداً، وبالتالي اعتمدت على مشاهدات الغير، وعلى ما أسمعه أيضاً. اعتقد أني مثل الكثيرين أعيش في شبكة تتناول أخبار الأزمة السورية، لا أخرج منها حتى في نومي".
وأضاف "ربما لأننا في دمشق في ظل حصار أمني محكم، لم أتمكن من متابعة المظاهرات إلا بمحض المصادفة البحتة، فلم ألمح من المظاهرات الطيارة إلا الشبان وهم يختفون في الحارات والأسواق، وما تركوه خلفهم أحياناً من قصاصات المنشورات، أو كتابات على الجدران، وما سمعته من شعارات وهتافات. على كل حال عوّض عنها جزئياً أفلام الفيديو المنتشرة على اليوتيوب".
وأوضح"أما الحدث الذي شهدت جزءاً منه، وهزني في الأعماق، فهو مروري إلى جانب جامع زيد بن ثابت في شهر رمضان، بعد حضوري لعزاء في صالة قريبة، لاحظت عندما كنت أتمشى في الشارع ثلاث باصات، وميكروباصين في داخلهم بعض الجنود المسلحين بالكلاشنكوفات والمسدسات يطلون من النوافذ، ما تبقى منهم كانوا يتجولون على الأرصفة الملاصقة بانتظار خروج المصلين من الجامع بعد صلاة التراويح. وكان مع الجنود ورجال الأمن، شبان يعملون في مؤسسات الدولة ومعهم حزبيون يحملون العصي والهراوات. فجأة انطلق من داخل المسجد المغلق الأبواب هتاف كهدير الرعد «الله أكبر»، وفي الوقت نفسه انفتح الباب الجانبي وخرجت منه النسوة المصليات، أخرجهم المتظاهرون لئلا يتعرضون لأذى الشبيحة الذين هرعوا إلى باب الجامع الرئيسي للهجوم على الشبان العزل بأسلحتهم وهراواتهم. في ذلك اليوم تدخل أهالي باب سريجة والمجتهد وقبر عاتكة في الفصل بينهما، كان أبناؤهم في الداخل، نجحت المفاوضات ومضت الواقعة على خير، كان الشبيحة كمن غرق في بحر من البشر، قد يورطهم مع أهالي الأحياء المجاورة باشتباك يؤدي إلى مجزرة".
وقال "هذا مشهد صغير، لكنك تدرك أبعاده، وما سينجم عنه، هؤلاء الشبان تظاهروا وهم يعرفون عواقبه، الاعتقال والتعذيب والسجن إلى مدد طويلة، عدا الضرب في لحظة القبض عليهم، ضرباً قد يودي إلى الإعاقة، وربما الموت".
وبشأن ما كتبه عن أحوال دمشق، ولم يكن مضى على الثورة أشهر قليلة، ماذا يقول اليوم في أحوال دمشق في ظل الثورة بعد مضي كل هذا الوقت؟.
أكد حدّاد" لاشك أنه طرأت متغيرات كثيرة على دمشق، هذا من موقعي المتواضع كمراقب، فقد أصبح لكل حي ومنطقة شهداؤها وتنسيقياتها، وباتت المظاهرات الطيارة والاعتصامات يومية وفي أكثر من مكان، كذلك حملات البخاخين على الجدران، إضافة إلى اشتباكات تجري في أحياء دمشق كركن الدين والشيخ محي الدين والميدان وكفرسوسة والمهاجرين والمزة. عدا مبادرة شبان وشابات في الشوارع الرئيسة من دمشق إلى رفع لافتات تدعو لوقف القتل على الرغم من خطر الاعتقال".
وقال "تفاقم الاحتجاجات السلمية أدى إلى رفع منسوب الاعتقالات ومداهمة البيوت ومراكز عمل الناشطين وتفتيشها، ومحاصرة المساجد في أيام الجمع لمنع خروج المظاهرات، وانتشار الحواجز الأسمنتية وقطع الطرقات الرئيسة والفرعية، وشيوع الاستحكامات وأكياس الرمل والجنود بملابس الميدان، ما انعكس على العملية الانتخابية لمجلس الشعب أخيراً بخلو خيم مضافات الناخبين من المؤيدين، ولا جدوى الدعايات الانتخابية.
وانعكس على الناس بمظاهر الترقب والتحفز والانقباض النفسي، لاسيما والأخبار ترد من حمص وحماة وأدلب ودير الزور ودرعا، ومعها قدوم آلاف اللاجئين من الشيوخ والرجال والنساء والأطفال، وكل منهم يحمل بين جوانحه أكثر من مأساة".
وأكد أن "دمشق على غير ما عهدناها، تختزن في داخلها، ما يشق عليها احتماله، تحمل هموم وطن بأسره.. ما الذي يحدث؟ ولماذا؟ هذا ما تراه على وجوه الدمشقيين. أما آن للحياة أن تعود، وللعقل أن يستعاد، وللبصر أن يسترشد بالبصيرة؟.
وهل يجد أن دمشق تأخرت فعلاً عن ركب الثورة؟ لماذا؟
يقول "نعم تأخرت، ومعها حلب، والأسباب معروفة؛ التمركز الأمني الشديد، لا ننسى أن معاقل الأجهزة الأمنية الكبرى في هاتين المدينتين، كذلك مؤسسات الدولة وإداراتها. واحتواء العاصمة على أعداد كبيرة من مؤيدي النظام المتنفعين منه، والذين يعتقدون أنهم مهددون في حال زواله، إضافة إلى جمهور الأحزاب المتعاونة، والكثير ممن يشغلون وظائف في الدولة. ما يسهل عملية قمع أي تحرك بسرعة وشدة. لكننا شهدنا مؤخراً مظاهرات جامعة حلب والمدينة الجامعية، وتشييع شهيد المزة في دمشق، وما انطوت عليه الحادثتان من دلالات عن احتقان الأهالي واستعدادهم للانضمام تلقائياً إلى الحراك".
وأضاف حدّاد "لا أعتقد أن هناك مدينة أو بلدة في سورية، لا تشارك في الاحتجاج، أو لا تحس بهذا الانهيار المتدرج من السيئ إلى الأسوأ، وإن اختلف من منطقة لأخرى، الجميع تحت الوطأة نفسها، والخوف نفسه، والرعب من حرب أهلية بدأت تلوح نذرها".
وأضاف"لا، ليس هناك من هو بمعزل عما يجري، ولا خارج هذا العذاب، ولا تلك التساؤلات والمخاوف".
وعن رأيه في الجيل الجديد، وعن القيم الجديدة التي أفرزتها الثورة.
قال حداد "لو أن أحداً كتب رواية الآن عن مجريات الانتفاضة وبطولات الشبان الصغار، أولاد المدارس والجامعات، ومواقف آبائهم وأمهاتهم، لاعتقد القراء المخضرمون أنهم يقرأون رواية على غرار «الأم» لمكسيم غوركي، أو لعصور الاستشهاد الإسلامية والمسيحية، من حيث التضحية والنبل والتفاني والتعاون والتآزر، وروح التحدي والفداء في سبيل الحرية. ما أظهره الأهالي من تفوق أخلاقي جعلنا نؤمن بأن البشر في أحلك الظروف، عكس ما نعتقد لا تتضاءل إنسانيتهم، بقدر ما تتجلى بأبهى صورها وهم يتقاسمون الخبز والدفء والكهرباء، ويتضامنون في ليالي الضراء ولحظات السراء النادر".
وأضاف"شبان صغار يتعرضون في الشوارع والجامعات للضرب بالعصي والإهانة والرفس بالأرجل، وللوشاية والتعذيب يمارسه عليهم زملاؤهم الطلاب بحقد أعمى، تحت حماية رجال الأمن. هذا يحيلنا إلى الشبيحة، وهي تقليعة محلية سورية وظاهرة على غرار البلطجية والزعران، أعاد النظام الاعتبار لها، بحيث لم نعد نستهجن رؤية مظاهرات يمشي في مقدمتها المعلمون والمعلمات، تضم صبية المدارس وهم يهتفون "شبيحة دبيحة". بل والأسوأ أنهم باتوا مثالاً منشوداً للشبان المتعاطفين مع النظام، ومنهم طلبة جامعات يتشبهون بهم ويقلدون أفعالهم".
وقال"لن ترى أكثر حماسة ولا قسوة ولا غطرسة من الشبيحة، يهرعون بكل قواهم إلى سحق أي احتجاج سلمي بكل أريحية، وكلهم إيمان وجرأة، بأنهم يفعلون الشيء الصحيح، بموجب اعتقاد جازم أن هؤلاء الشبان خونة للوطن لمجرد أنهم يهتفون للحرية، وللشعب السوري الواحد، ولو أن قوات الجيش، لا تنقذهم منهم، وتعتقلهم، لذاقوا الأمرين. هناك من مات تحت أقدام الشبيحة، فيا لعظمة الذود عن النظام بهذا الأسلوب الوحشي".
وأوضح"طبعاً، ما لمسناه غيّر رأينا في الأجيال الجديدة. كنا ننتقد دائماً غربتهم عن السياسة وافتقادهم إلى حس وطني، وعدم الاهتمام بمشكلات سورية. ما يفعلونه اليوم، نحن عاجزون عن فعله، ويشعرنا بتقصيرنا تجاه البلد".
وأخيراً ما معنى عدم انتسابك حتى الآن إلى «اتحاد الكتاب العرب»؟ هل هو موقف مبكر من النظام ومؤسساته؟ وهل يقع ضمن هذا السياق انخراطك الفوري في «رابطة الكتاب السوريين» التي تشكلت أخيراً كمؤسسة بديلة؟
يقول حدّاد "اتخذت قراري بشكل مبكر وعن قناعة مطلقة، بعدم الانتساب إلى اتحاد الكتاب العرب، لم يكن اختياري للكتابة، إلا لأن الكتابة حرية. كان واضحاً من دون تفكير مطول أن ارتباطي بالاتحاد أو غيره، وكل ما له علاقة بالدولة، سيصبح قيداً علي ككاتب، ويضطرني إلى الرضوخ لأشياء لا أرضاها. ببساطة الاتحاد جهاز تابع للدولة ويشرف عليه حزب البعث، ويتدخل في التعيين والإقصاء، وفي الانتخابات يترك للمستقلين أو ما شابه هامشاً صغيراً. هذا إضافة إلى اعتراضي على مفهوم الرقابة في الاتحاد بشكل العام، وعلى إجراءاتها بشكل خاص، حيث يقوم الكتاب أنفسهم بمراقبة ما يكتبه زملاؤهم".
وأضاف"أما السبب الرئيسي والأول، فهو اعتقادي أنه من قصر النظر انضواء الكاتب تحت أي تنظيم، إذ ليس من الضروري أن تجتمع كلمة الكُتاب على شيء، ولا أن يصطبغوا بلون موحد، الأفضل أن يكونوا متفرقين، إذ بقدر ما تتعدد الرؤى وتتناقض الآراء، يغتني الأدب".
وأوضح"أما انضمامي لرابطة الكتاب السوريين، فيقع في سياق آخر، هو تسجيل موقف إزاء ما يحدث في سوريا، وإعلان بتضامني مع شعبي في محنته، وهي مسؤولية لا يجوز التنصل منها. بعد انتهاء الأزمة أو الثورة سأنسحب من الرابطة".
وقال حدّاد "إذا كان من المستحسن ألا ينضم الكاتب لأي تجمع أو مؤسسة، فهو ليس فوق الناس ولا المؤسسات، ولا يختلف عن غيره، إنما في أن عمله لا يصح إلا إذا كانت اختياراته تتم بعيداً عن أية جهة، ومن دون أفكار مسبقة".
يشار إلى أن فوّاز حدّاد روائي سوري معروف ولد في دمشق وحصل على إجازة في الحقوق من الجامعة السورية 1970، تنقل بين عدة أعمال تجارية، امتدت سنوات طويلة. خلالها كتب في القصة القصيرة والمسرح والرواية، دون أية محاولة للنشر. أصدر أول رواياته العام 1991. لديه أحدى عشر روايات ومجموعة قصص قصيرة.
شارك كمحكم في مسابقة حنا مينة للرواية، ومسابقة المزرعة للرواية في السويداء. كذلك في الإعداد لموسوعة "رواية اسمها سورية". تفرغ للعمل الروائي كلية في العام 1998، وأعماله الروائية "موزاييك ـدمشق 39".رواية إصدار العام1991، "تياترو 1949". رواية إصدار العام1994، "صورة الروائي"رواية إصدار العام1998، "الولد الجاهل"رواية إصدار العام2000، "الضغينة والهوى" رواية إصدار العام2001، "مرسال الغرام" رواية إصدار العام 2004، "مشهد عابر" رواية إصدار العام 2007، "المترجم الخائن" رواية إصدار العام 2008. الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) القائمة القصيرة العام 2009، "عزف منفرد على البيانو" رواية إصدار العام 2009، "جنود الله" رواية إصدار العام 2010، "خطوط النار" رواية إصدار العام 2012. ومجموعة قصص قصيرة تحت عنوان "الرسالة الأخيرة" إصدار العام 1994.
GMT 16:11 2025 الأحد ,10 آب / أغسطس
وزير الخارجية الإيراني يُحذر من استهداف القواعد الأميركية في المنطقة بالصواريخ إذا اندلعت حرب جديدةGMT 19:41 2025 الخميس ,07 آب / أغسطس
الرئيس اللبناني يؤكد أن حصرية السلاح بيد الدولة ستتحقق رغم التحدياتGMT 10:54 2022 الأحد ,16 تشرين الأول / أكتوبر
أنطونيو غوتيريش يُرحب بتوقيع الفصائل الفلسطينية على "إعلان الجزائر"GMT 08:48 2022 الخميس ,13 تشرين الأول / أكتوبر
زيلينسكي يرغب في مساعدات مالية دائمة لأوكرانياGMT 11:17 2022 الأربعاء ,12 تشرين الأول / أكتوبر
ستولتنبرغ يُحذر روسيا من عواقب وخيمة إذا استخدمت أسلحة نوويةGMT 08:51 2022 الثلاثاء ,11 تشرين الأول / أكتوبر
البرهان يكشف عن تسوية وشيكة لحل أزمة السودان بوساطة أمميةGMT 15:27 2022 الإثنين ,10 تشرين الأول / أكتوبر
ينس ستولتنبرغ يؤكد أن الهجمات الروسية على البنى التحتية الأوكرانية مروعةGMT 12:43 2022 السبت ,08 تشرين الأول / أكتوبر
وزير الخارجية السعودي يؤكد أن بلاده لا تستخدم النفط سلاحًا ضد أميركاتوقيع اتفاقيتين لتسهيل مرور أنبوب الغاز "المغربي-النيجيري"
الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط توقيع مذكرات تفاهم بين شركة النفط الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن المغربي وشركة النفط السينغالية وشركة محروقات الموريتانية حول مشروع غاز نيجيريا-الم�...المزيدتامر حسني يؤكد إستمرار علاقته الفنية مع بسمة بوسيل ويكشف دعم محمد منير له منذ بداياته
القاهرة - الدار البيضاء اليوم
أحيا الفنان تامر حسني واحدة من أضخم حفلات صيف 2025 برأس الحكمة بالساحل الشمالي بحضور الآلاف من جمهوره من مختلف الجنسيات العربية . بدأ الحفل بصعود تامر حسني على خشبة المسرح مرددًا "ميدلي" استعراضي يضم عددًا من أغ�...المزيدانتقادات واسعة لـ"خرائط انستجرام" بسبب مخاوف الخصوصية وخطوات تعطيل الميزة
سان فرانسيسكو - الدار البيضاء اليوم
أثارت ميزة "خرائط انستجرام" الجديدة موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي بعد أيام قليلة من إطلاقها، حيث عبر عدد من المستخدمين عن استيائهم وقلقهم من تداعيات الميزة على الخصوصية الشخصية. واتهم البعض ا...المزيدرحيل صوت الحرية في الأدب العربي المصري صنع الله إبراهيم عن عمر 88 عامًا المتمرّد الذي ظلّ وفيًا للكتابة
القاهرة - الدار البيضاء اليوم
توفي اليوم الكاتب والروائي المصري صنع الله إبراهيم عن عمر ناهز 88 عامًا، بعد معاناة صحية بدأت منتصف عام 2025 عقب إصابته بنزيف داخلي وكسور في الحوض، قبل أن تتدهور حالته مؤخرًا بسبب التهاب رئوي حاد. وقد شكّل خبر وفاته لح�...المزيدجورجينا تثير اهتمام الجمهور بعد موافقتها على الزواج وتخطف الأنظار بأجمل إطلالاتها
الرياض - الدار البيضاء اليوم
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
























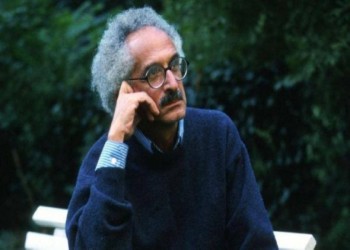

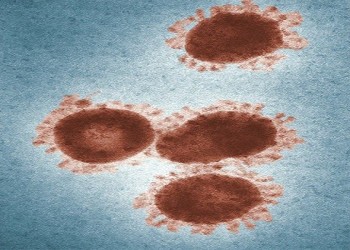





أرسل تعليقك
تعليقك كزائر